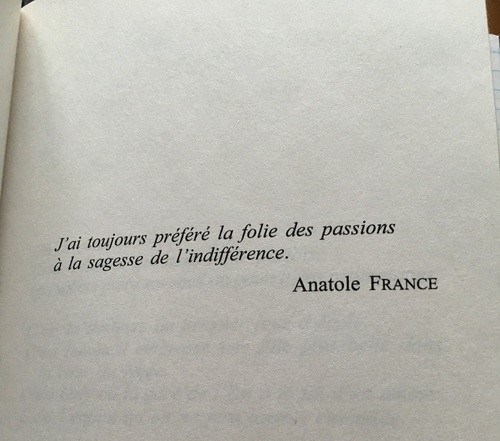
القانــون ميّــت و لكــن القاضــي حــيّ[1]
أناتــول فرانــس[2]
ترجمــة
د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــرى
23 أغسطس، 2017
–
“منذ بضعة أيام”، قال السيد مارتو، “صادف أننى كنت مستلقياً على أجمة فى غابة فيسين”.[3]
“لم آكل شيئاً منذ ستٍ و ثلاثين ساعة”. مسح السيد جوبان نظارتيه، كانت له عينان طيبتان، و لكن بنظراتٍ تشعّ اهتماماً. نظر إلى جان مارتو بتركيز و قال له بنبرةٍ فيها شيءٌ من الملامة:
“ماذا؟ ألمرةٍ أخرى لم تأكل شيئاً منذ أربع ٍو عشرين ساعة؟”
“لمرةٍ أخرى” أجاب مارتو،” لم آكل شيئاً منذ أربع و عشرين ساعة. و لكننى كنت مخطئاً. لا يصحّ للمرء أن يمضى من دون طعام. هذا ليس صحيحاً. ينبغي أن يعتبر الجوع جريمة، مثله كمثل التشرّد. و لكن هاتان الجريمتان، في حقيقة الأمر، يُنظر لهما كشئٍ واحدٍ بالنهاية، فالمادة 269 تعاقب بالسجن لمدةٍ تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر كل من يفتقر إلى وسائل العيش. التشرّد، وفقاً للقانون، هو سمة الجوّابين، شذّاذ الآفاق، الأشخاص الذين لا مسكن ثابت لهم أو مواردٍ للرزق، و الذين لا يمارسون صنفاً محدداً من التجارة أو المهنة؛ إنهم مجرمون من الطراز الأول”.
“أنه أمرٌ مثيرٌ للاهتمام” قال السيد بيرجيريه، “أن حالة التشرّد التى تُعاقب بستة أشهرٍ من الحبس و عشر سنواتٍ من رقابة الشرطة هى تحديداً الحالة التى كان القدّيس فرانسيس[4] قد جعل عليها رفاقه في كل من سلك القدّيسة مريم ذات الملائكة[5] و بنات القديّسة كلارا.[6] لو كان القدّيس فرانسيس الأسيزي و القدّيس أنطونيو اللشبوني[7] قد حضرا إلى باريس لإلقاء المواعظ اليوم فإنهما كانا سيخاطران بأن يوثقا و يرميا فى عربة السجن ثم يساقا إلى محكمة الشرطة. ليس الأمر هو أنني أروم التنديد أمام السلطات بالرهبان المتسوّلين الذين يجولون بيننا الآن، فلهؤلاء مصادرٌ للرزق؛ إنهم يمارسون جميع أصناف التجارة”.
“إنهم محترمون لأنهم أغنياء”، قال جان مارتو. “الفقراء فقط هم من يُمنعون من الاستجداء. لو كان قد تم إكتشافى تحت شجرتى لكان قد أُلقي بى فى السجن، و كان ذلك سيُكون عدلاً. لأننى لا أمتلك شيئاً، سأُعتبر عدواً للملكيّة؛ فالأمر بالنهاية يتعلق بحماية الملكيّة ضد أعدائها. إن أجلّ مهامّ القاضى هى أن يضمن لكل شخصٍ ما يعود له، للغنىّ غناه و للفقير فقره”.
“لقد فكّرت فى فلسفة القانون”، قال السيد بيرجيريه، “و وجدت أن هيكل العدالة الإجتماعية بأكمله يقوم على مسلّمتين: إدانة السرقة، مع احترام نتيجتها. هذان هما المبدآن اللذان يضمنان أمان الأفراد و يحفظان النظام فى الدولة. لو أن واحداً من هذين المبدئين الوصائيّين تم خرقه فإن بناء المجتمع بأكمله سيتداعى. هذان مبدآن وُضعا منذ بدء الزمان. هناك زعيم قبيلةٍ ما – متدثراً برداءٍ من جلد دبٍ و مسلحاً بفأسٍ من الصوّان و سيفٍ من البرونز – عاد مع رفاقه إلى حصنهم الصخرى، حيث كان أطفال القبيلة مودَعين و معهم كتائبٍ من النساء و حيوانات الرنّة، فجلبوا معهم بعض الفتية و الفتيات من أبناء القبائل المجاورة و شيء من الحجارة المتساقطة من السماء، التى اعتبرت ثمينةً لأنهم كانوا يصنعون منها السيوف التى لا تنثنى. تسلّق الزعيم تلةّ صغيرةّ فى الجوار، و قال “هؤلاء العبيد و هذا الحديد، الذين أخذتهم من رجاٍل ليني العريكة و محتقرين، هم لى. كل من تُسوّل له نفسه أن يضع يده عليهم سوف أضربه بفأسي”؛ هذا هو أصل القانون. إن روحه قديمةٌ و بربرية، و الناس لا يجدون الطمأنينة فى العدالة إلا من حيث هى تصديقٌ لكل ما سبقها من المظالم”.
“يمكن أن يكون القاضى مُحسناً، فليس جميع الرجال أشرار؛ أما القانون فلا يمكن أن يكون كذلك لأنه سابقٌ على جميع أفكار الإحسان. أن التغييرات التى لحقت به على مرّ الأزمنة لم تغيّر فى طبيعته الأصلية. جعل الفقهاء منه هادئاً، و لكنهم أبقوا عليه بربرياً. أن وحشيته هى ما يجعل منه محترماً و ومرهوب الجانب. لقد اعتاد الناس على عبادة الآلهة الشريرة، أما ما خلا من القسوة فلا يبدو لهم مستحقاً للعبادة. و المحكوم عليه يؤمن بعدالة القانون، إذ أن مرجعيّته الأخلاقية هى ذات مرجعيّة القضاة، فالكل يؤمن بأن جزاء التصرف المُجرَّم هو العقاب. فى كلٍ من مخفر الشرطة و المحكمة كان يؤثّر بى أن أرى كيف أن كلاً من المتهم و القضاة كانوا يتفقون بشكلٍ عامٍ في أفكارهم حول الخير و الشر؛ فلديهم جميعاً نفس التحيّزات و يشتركون فى ذات المنظومة الأخلاقية.
“الأمر لا يمكن أن يكون على خلاف ذلك”، قال جان مارتو. “إن مخلوقاً فقيراً سرق من نافذة دكّانٍ ما قطعة سجقٍّ أو زوجٍ من الأحذيةٍ ما كان ليبحث فى هذا الصدد فى أصل القانون و أساس العدالة بعمقٍ و فطنة، أما هؤلاء الذين على شاكلتنا ممن لا يتهيّبون من أن يروا فى أصول التشريعات رخصةً بالعنف و الإثم، فهم لا يستطعون حتى سرقة نصف قرش”.
“و لكن و رغم كل شئ”، قال السيد جوبان، “هناك قوانينٌ منصفة”.
“هل تعتقد ذلك؟” تساءل جان مارتو.
“السيد جوبان محق”، قال السيد بيرجيريه. “هناك قوانينٌ عادلة. و لكن لما كان القانون قد نشأ لحماية المجتمع، فهو فى روحه لا يمكن أن يكون أكثر عدلاً من المجتمع الذي ما وضع إلا لحمايته. ما دام المجتمع قد تأسّس على الظلم فإن وظيفة القوانين ستكون حماية هذا الظلم و دعمه. و كلما كانت القوانين أكثر ظلماً كلما ظهرت أكثر استحقاقاً للاحترام. لاحظ أيضاً أنه لما كانت أكثر هذه القوانين قديمة، فإنها لا تمثل حالة الإثم الحالى بل الإثم القديم الذى يتّسم بأنه أكثر فجاجةً و بلادة. إنها أنصبةٌ تذكاريةٌ للعصور المظلمة التى دامت إلى أن جاءت الأيام الأكثر أستنارة”.
“و لكنها في طور التحسّن”، قال السيد جوبان.
“إنها في طور التحسّن”، قال السيد بيرجيريه. “البرلمان و مجلس الشيوخ يعملون عليها عندما لا يكون أمامهم شيئٌ آخرٌ يفعلونه. و لكن قلب هذه القوانين كما هو، و هو مرّ. و حتى أكون صريحاً، فأنا لا أخاف من القوانين السيئة مادامت تُطبّق على يد قضاةٍ صالحين، القانون لا ينحنى، كما يُقال، و لكنى لا أصدّق ذلك. ليس هناك نصٌ لا يمكن تفسيره على أكثر من وجه. القانون ميّت، و لكن القاضى حىّ: أن له سلطاناً عظيماً على القانون. لسوء الحظ فإنه نادراً ما يستخدمه. إنه يدرّب نفسه عادةً على أن يكون بارداً، أقل إحساساً، و أكثر موتاً من القانون الذى يطبّقه. إنه ليس بشراً؛ فلا يعرف الشفقة، لأن روح الطبقة التي بداخله تخنق كل عاطفةٍ إنسانية.
“أنا اتحدث الآن عن القضاة النزيهين فقط”.
“إنهم الغالبية”، قال السيد جوبان.
ردّ السيد بيرجيريه “إنهم الغالبية، إذا ما كنا نقصد النزاهة الاعتيادية و الأخلاق اليومية. و لكن هل مقاربة الأمانة الشائعة تعتبر كافيةً لرجلٍ مكلّفٍ بممارسة سلطة العقاب المهولة، من دون الوقوع فى الخطأ أو التعسف؟ أن القاضى الجيد ينبغي أن يكون له فى الآن ذاته قلبٌ طيبٌ و عقلٌ فلسفى. و لكن هذا مطلبٌ كبيرٌ من شخصٍ يُفترض به أن يشقّ طريقه فى الحياة و ذو تصميمٍ على التطوّر في مهنته، هذا إذا ما استبعدنا أنه إن أظهر حساً أخلاقياً رفيعاً متعالٍ على زمنه فإنه سوف يُلاقى الكره من قبل زملائه و سوف يثير استنكاراً عاماً، لأننا ندين كلّ حسٍ يخالف حسّنا فنصمه بأنه لا أخلاقيّ. إن كل من قدّم شيئاً طيباً جديداً إلى هذا العالم جوبه بسخرية الناس الطيّبين. هذا ما حدث للرئيس مانيو.”[8]
“لدىّ أحكامه هنا، مجمّعةً فى مجلّدٍ صغير مع تعليقاتٍ وضعها هنري ليريه. عندما تمّ النطق بهذه الأحكام، أثار الأمر استنكار القضاة المتزمّتين و المشرّعين المتسامين. لقد كانت هذه الأحكام مزدحمةً بالأفكار النبيلة و العاطفة الرقيقة، و كانت ملأى بالشفقة، إنسانيّة، و تنحو نحو الفضيلة. و لكن فى محاكم القانون كان يُنظر إلى الرئيس مانيو باعتباره شخصٌ ذو عقلٍ غير قانونىّ، كما أن أصدقاء السيد ميلين[9] اتهموه بعدم احترام فكرة الملكيّة. و الحق أن الاعتبارات التى استندت إليها أحكام الرئيس مانيو لها طبيعةٍ فرديّة، ففى كل سطرٍ يلتقى المرء بأفكار عقلٍ مستقلٍ و عواطف قلبٍ كريمٍ”.
تناول السيد بيرجيريه مجلداً قرمزياً من المنضدة، و بدأ يقلّب صفحاته، و يقرأ:
– “الأمانة و الدقة هى فضيلتان من السهل على المرء أن يمارسهما إلى ما لا نهاية عندما لا يكون مفتقراً إلى شئ، بالمقارنة بما إذا كان محروماً من كل شئ”.
– “ما لا يمكن تجنّبه لا يستقيم توقيع العقاب عنه”.
– “حتى يمكن أن يحكم على الجريمة أو على الفقير بعدالة، على القاضى أن ينسى وضعه المريح للحظة، ليضع نفسه ما استطاع فى الموضع الحزين لهذا الذى هجره الجميع”.
– “فى تفسيره للقانون، على القاضى ألا يحصر تفكيره فى الحالة الخاصة المعروضة عليه، بل أن يأخذ فى الاعتبار النتائج الأوسع لحكمه و ما يمكن أن ينطوي عليه من الآثار الخيرةٍ و السيئة”.
– “العامل وحده هو من ينتج و من يخاطر بصحته أو بحياته لتحقيق ربحٍ يؤول حصراً إلى رب عمله، الذى لا يخاطر بدوره بشئٍ سوى رأسماله”.
“لقد سردتُ هذه الأقوال بشكلٍ اعتباطىّ”، أضاف السيد بيرجيريه، و هو يغلق الكتاب. “هذه كلماتٌ جديدة. إنها أصداء روحٍ عظيمة”.
–
–
[1] المصدر:
Anatole France, Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables.
[2] أناتول فرانس Anatole France (1844-1924): كاتب و ناقد فرنسي، تميز بالكتابة الساخرة. كان عضواً بالأكاديمية الفرنسية، و حاصل على جائزة نوبل في الآداب.
[3] غابة فيسين Bois de Vicennes: أكبر غابة في العاصمة الفرنسية باريس، تقع في شرق المدينة.
[4] القدّيس فرانسيس الأسيزي Saint Francis of Assisi (1181-1226): راهب كاثوليكي، كان ينبذ اعتزال الرهبنة فأسس السلك الفرنسيكاني (Franciscan Order) للدعوة بين الناس و البشارة بالبساطة و حب الله و جميع المخلوقات من بشرٍ و حيوان. يقال أنه وقع في أسر المسلمين أثناء الحملة الصليبية الخامسة، فأكرموه و أعادوه إلى جماعته.
[5] سلك القدّيسة مريم سيدة الملائكة (Saint Mary of the Angels): سلك ديني يتبع القدّيس فرانسيس الأسيزي، معقله هو كنيسة Basilica of Santa Maria degli Angeli في مدينة Assisi في إيطاليا.
[6] القديّسة كلارا الأسيزية Saint Clare of Assisi (1194-1253): راهب كاثوليكية، نادت بالتزهد و العيش من دون امتيازات.
[7] القدّيس أنطونيو اللشبوني Saint Anthony of Padua (1195-1231): راهب كاثوليكي برتغالي الأصل ينتمي للسلك الفرنسيكاني. كان يعرف بـ “مطرقة الهراطقة” لشدته في نشر العقيدة الكاثوليكية في أوساط المنشقين عن الإيمان.
[8] الرئيس مانيو President Magnaud (1848-1926): قاضي فرنسي يعرف بـ “القاضي الطيب” لأحكامه التي كان يتحرّى فيها الأنصاف للفئات الضعيفة رغماً عن التفسيرات التقليدية للقانون. كانت له شعبية كبيرة، و قد جمع H. Leyret أحكامه و نشرها في مجلد عام 1900.
[9] فيليكس ميلين Félix Méline (1838-1925): سياسي فرنسي كان رئيساً لوزار الجمهورية.
![11831783_10153461145211071_5527646639533534404_n[1]](https://eltibas.files.wordpress.com/2015/08/11831783_10153461145211071_5527646639533534404_n1.jpg?w=300&h=300)